احجز زيارة منزلية في الرياض و جدة وكل مناطق المملكة!
طبيب عام ومتخصص – ممرضة – علاج طبيعي – حجامة – أشعة – تحاليل طبية – استشاري نفسي.
مرض ذات الرئة (Pneumonia)
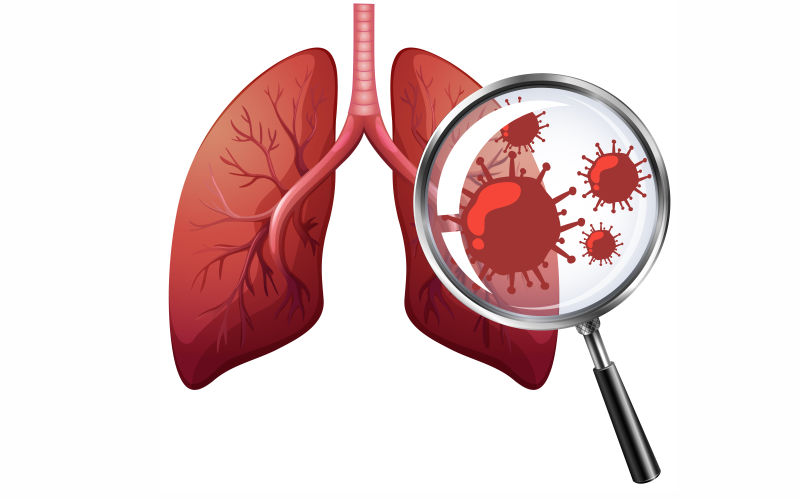
مرض ذات الرئة، أو الالتهاب الرئوي، هو عدوى تصيب الرئتين وتسبب التهاب الحويصلات الهوائية، وهي الأكياس الصغيرة المسؤولة عن تبادل الأكسجين في الرئتين. تمتلئ هذه الحويصلات بسائل أو صديد، مما يعيق عملية التنفس ويؤدي إلى أعراض تتراوح من خفيفة إلى شديدة.
أسباب مرض ذات الرئة
يمكن أن تسبّب ذات الرئة عدة أنواع من الكائنات الحية، منها:
1. البكتيريا
تُعد البكتيريا من أكثر الأسباب شيوعًا لذات الرئة، خاصة عند البالغين.
-
Streptococcus pneumoniae:
هو السبب الأكثر شيوعًا، وغالبًا ما يسبب ذات الرئة المكتسبة من المجتمع. يمكن أن تكون العدوى مفاجئة مع حمى مرتفعة، قشعريرة، وألم في الصدر. -
Haemophilus influenzae:
يسبب ذات الرئة خاصة عند كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من أمراض تنفسية مزمنة مثل الربو أو داء الانسداد الرئوي المزمن (COPD). -
Staphylococcus aureus:
قد تظهر العدوى بعد الإصابة بالإنفلونزا، وقد تكون شديدة في بعض الأحيان. -
Klebsiella pneumoniae:
تصيب غالبًا الأشخاص المدمنين على الكحول أو الذين لديهم مشاكل صحية مزمنة، وتسبب بلغمًا غليظًا مدمى يُعرف بـ”البلغم الجيلاتيني”.
2. الفيروسات
الفيروسات مسؤولة عن نسبة كبيرة من حالات ذات الرئة، خاصة عند الأطفال.
-
فيروس الإنفلونزا (Influenza):
من الأسباب الفيروسية الشائعة، وقد يضعف المناعة ويهيئ الجسم للإصابة بالبكتيريا أيضًا. -
فيروس كورونا المستجد (SARS-CoV-2):
يسبب التهاب رئوي فيروسي يمكن أن يتطور إلى متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS)، ويحتاج المريض في بعض الحالات إلى عناية مركزة. -
فيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV):
شائع عند الأطفال الرضع، وقد يسبب ذات الرئة أو التهاب القصيبات. -
فيروسات أخرى: مثل adenovirus وparainfluenza، تؤدي إلى التهابات خفيفة إلى معتدلة غالبًا.
3. الفطريات
نادراً ما تسبب ذات الرئة، وغالباً ما تصيب:
-
الأشخاص ذوي المناعة المنخفضة مثل مرضى السرطان، الإيدز، أو من يتناولون أدوية مثبطة للمناعة.
-
أنواع الفطريات المسببة:
-
Histoplasma capsulatum: ينتشر في مناطق تحتوي على فضلات الطيور.
-
Coccidioides: يوجد في المناطق الجافة مثل جنوب غرب الولايات المتحدة.
-
Pneumocystis jirovecii: يصيب بشكل خاص مرضى نقص المناعة، وكان في السابق سببًا شائعًا للوفاة بين مرضى الإيدز قبل استخدام العلاج الفعّال.
-
4. الميكوبلازما (Mycoplasma pneumoniae)
-
تُصنّف ضمن البكتيريا، لكنها صغيرة جدًا وتفتقر إلى الجدار الخلوي، ما يجعلها مميزة.
-
تسبب ما يُعرف بـ”ذات الرئة الماشية” أو “walking pneumonia”، حيث تكون الأعراض خفيفة نسبيًا ويمكن للمريض الاستمرار في أنشطته اليومية.
-
تنتشر أكثر بين صغار السن واليافعين، خصوصًا في البيئات الجماعية مثل المدارس أو الثكنات العسكرية.
5. أسباب أخرى نادرة
-
الاستنشاق: استنشاق مواد كيميائية أو محتوى المعدة (ذات الرئة الاستنشاقية).
-
العدوى المختلطة: قد يصاب المريض بأكثر من نوع واحد من الميكروبات (فيروس + بكتيريا مثلًا).
-
العدوى داخل المستشفيات: مثل Pseudomonas aeruginosa وMRSA، وهي خطيرة وتقاوم كثيرًا من المضادات الحيوية.
طرق العدوى
ينتقل المرض عادة عبر:
1. استنشاق الرذاذ المحمّل بالعدوى
-
تُعد هذه الطريقة الأكثر شيوعًا لانتقال ذات الرئة، خصوصًا تلك الناتجة عن الفيروسات أو البكتيريا.
-
عندما يسعل أو يعطس شخص مصاب، تنتشر قطرات صغيرة جدًا في الهواء، تحتوي على الميكروبات المسببة للمرض.
-
إذا استنشقها شخص قريب، يمكن أن تصل الجراثيم إلى الرئتين وتبدأ العدوى.
-
هذه الطريقة شائعة في الأماكن المغلقة والمزدحمة مثل المدارس، المكاتب، ووسائل النقل العام.
أمثلة:
-
فيروس الإنفلونزا
-
Streptococcus pneumoniae
-
فيروس كورونا المستجد
2. انتقال الجراثيم من الأنف أو الفم إلى الرئتين
-
في بعض الحالات، تكون الميكروبات موجودة أصلًا في الفم أو الحلق دون أن تسبب مشكلة.
-
لكن عند ضعف الجهاز المناعي، أو أثناء النوم، أو بسبب مشاكل في البلع (خصوصًا لدى كبار السن أو المصابين بجلطات دماغية)، يمكن أن تنزلق هذه الجراثيم إلى القصبة الهوائية ثم إلى الرئتين.
-
تُعرف هذه الحالة أحيانًا باسم العدوى الانسدالية أو العدوى من الفم البلعومي.
شائعة لدى:
-
المسنين
-
المصابين بأمراض عصبية
-
المرضى المصابين بغيبوبة
3. العدوى المكتسبة داخل المستشفى (Hospital-acquired pneumonia)
-
تصيب المرضى أثناء وجودهم في المستشفى، خاصة من يخضعون لعلاج طويل أو أجهزة تنفس صناعي.
-
هذه العدوى تكون غالبًا أكثر خطورة لأن الجراثيم المسببة لها مقاومة للمضادات الحيوية.
من أبرز العوامل المهيئة:
-
وجود أنبوب تنفس (التهوية الميكانيكية).
-
ضعف المناعة بسبب الجراحة أو أدوية مثبطة للمناعة.
-
الإقامة في وحدة العناية المركزة (ICU).
أشهر الجراثيم المرتبطة بها:
-
Pseudomonas aeruginosa
-
MRSA (Staphylococcus aureus المقاوم للميثيسيلين)
4. العدوى عبر الاستنشاق الكيميائي أو السوائل (Aspiration pneumonia)
-
تحدث عندما يستنشق الشخص عن طريق الخطأ الطعام، أو الشراب، أو القيء، أو اللعاب إلى الرئتين.
-
المواد المستنشقة قد تحتوي على بكتيريا تسبب الالتهاب.
-
لا تحدث هذه الحالة نتيجة جراثيم منتقلة من الخارج، بل نتيجة دخول مواد ضارة للرئة.
شائعة لدى:
-
الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في البلع
-
المرضى تحت التخدير أو التأثير الكحولي
-
من لديهم مشاكل في الأعصاب أو العضلات
5. العدوى من الدم (Hematogenous spread) – نادرة
-
في بعض الحالات النادرة، تنتقل العدوى من أعضاء أخرى في الجسم عبر الدم وتصل إلى الرئتين.
-
مثال: إذا كان هناك التهاب في صمام القلب أو في الجلد، قد تنتشر البكتيريا عبر مجرى الدم وتسبب التهابًا رئويًا.
الأعراض التفصيلية لمرض ذات الرئة
1. السعال (Cough)
-
من أكثر الأعراض شيوعًا.
-
قد يكون جافًا في حال العدوى الفيروسية أو الميكوبلازما.
-
وقد يكون مصحوبًا ببلغم في حالات العدوى البكتيرية.
-
أحيانًا يكون البلغم مدمّى أو ذا لون أصفر/أخضر كثيف يدل على وجود صديد.
2. الحمى والقشعريرة (Fever and Chills)
-
ارتفاع حرارة الجسم علامة على محاولة الجسم مكافحة العدوى.
-
قد تكون الحمى شديدة في العدوى البكتيرية، وتُرافقها قشعريرة شديدة وتعرّق غزير.
-
في حالات العدوى الفيروسية، تكون الحمى متوسطة أو خفيفة.
3. ضيق التنفس (Shortness of Breath)
-
يظهر نتيجة امتلاء الحويصلات الهوائية بالسوائل أو الصديد، مما يعيق تبادل الأكسجين.
-
يزداد سوءًا مع المجهود، وقد يصل إلى درجة صعوبة التنفس أثناء الراحة في الحالات الشديدة.
4. ألم في الصدر (Chest Pain)
-
يكون ألمًا حادًا يشبه الطعن، يزداد عند التنفس العميق أو السعال.
-
ناتج عن التهاب الغشاء المحيط بالرئتين (غشاء الجنب).
-
قد يُخطأ البعض ويظنه ألم قلب، لذلك الفحص الطبي مهم جدًا.
5. الإرهاق العام (Fatigue)
-
شعور شديد بالتعب وفقدان للطاقة.
-
نتيجة المجهود الكبير الذي يبذله الجسم لمحاربة العدوى، ونقص الأكسجين.
6. تسارع ضربات القلب (Tachycardia)
-
بسبب الحمى وانخفاض الأكسجين، يحاول القلب تعويض ذلك بضخ الدم بسرعة أكبر.
-
قد يشعر المريض بخفقان أو نبضات سريعة وغير منتظمة.
7. أعراض إضافية محتملة
-
الصداع وآلام العضلات: خاصة في الحالات الفيروسية.
-
فقدان الشهية.
-
الغثيان أو القيء: خصوصًا عند الأطفال.
عند الفئات الخاصة
👵 كبار السن
-
قد لا تظهر الأعراض التقليدية مثل الحمى أو السعال.
-
بدلًا من ذلك، قد يُلاحظ:
-
تغيرات في الوعي أو التشوش الذهني المفاجئ.
-
هبوط في درجة حرارة الجسم (hypothermia).
-
تفاقم الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب أو السكري.
-
سقوط أو ضعف غير مبرر.
-
👶 الأطفال والرضع
-
الأعراض قد تختلف وتكون غير واضحة:
-
صعوبة في الرضاعة أو قلة الشهية.
-
تنفس سريع أو صفير.
-
شحوب أو زرقة في الشفتين.
-
بكاء مستمر أو خمول غير معتاد.
-
تشخيص مرض ذات الرئة
1. الفحص السريري (Clinical Examination)
يبدأ الطبيب دائمًا بالفحص البدني، والذي يشمل:
-
الاستماع للرئتين بالسماعة الطبية:
يُسمع عادة صوت “خرخرة” أو “صفير” أو أصوات فرقعة (crackles) تدل على وجود سوائل في الرئة. -
مراقبة نمط التنفس:
يُلاحظ إن كان التنفس سريعًا أو غير طبيعي. -
فحص درجة الحرارة، النبض، وضغط الدم:
للكشف عن علامات الحمى، انخفاض ضغط الدم، أو تسارع ضربات القلب. -
التحقق من الأعراض الأخرى: مثل الألم عند التنفس، تغير لون الشفتين (زرقة)، أو الإرهاق الشديد.
2. صورة أشعة للصدر (Chest X-ray)
-
أداة أساسية في تأكيد تشخيص ذات الرئة.
-
تُظهر وجود مناطق من التعتيم (opacities) في الرئة، مما يدل على وجود التهاب أو سوائل.
-
تساعد في:
-
تحديد موضع الإصابة (فص علوي، سفلي، جهة واحدة أو الجهتين).
-
تمييز ذات الرئة عن أمراض صدرية أخرى مثل فشل القلب أو السرطان.
-
متابعة تحسن الحالة بعد العلاج.
-
3. تحاليل الدم (Blood Tests)
أ. تعداد الدم الكامل (CBC):
-
ارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء (WBC) يُشير إلى وجود عدوى.
-
أحيانًا يكون هناك انخفاض في WBC في العدوى الفيروسية الشديدة أو عند ضعف المناعة.
ب. مؤشرات الالتهاب:
-
مثل CRP (C-reactive protein) وESR، ترتفع في حالات الالتهاب وتساعد على تقييم شدة المرض.
ج. تحليل غازات الدم (ABG):
-
يُستخدم في الحالات الشديدة لتقييم نسبة الأوكسجين وثاني أكسيد الكربون في الدم.
-
يُظهر مدى تأثر وظائف الرئة.
4. فحص البلغم (Sputum Culture and Gram Stain)
-
يُطلب من المريض بصق عينة من البلغم لتحليلها مخبريًا.
-
الهدف:
-
تحديد نوع الميكروب المسبب للعدوى (بكتيريا، فطريات، إلخ).
-
معرفة مدى حساسية الميكروب للمضادات الحيوية.
-
ملاحظة: يجب أخذ العينة قبل بدء المضاد الحيوي للحصول على نتائج دقيقة.
5. اختبارات إضافية (عند الحاجة)
أ. المزرعة الدموية (Blood Culture):
-
للكشف عن البكتيريا التي انتشرت في الدم.
-
مهمة في الحالات الشديدة أو عند الاشتباه بتسمم الدم (Sepsis).
ب. اختبار البول للأجسام المضادة (Urinary Antigen Test):
-
يُستخدم للكشف عن بكتيريا معينة مثل Legionella وStreptococcus pneumoniae.
ج. التصوير المقطعي (CT Scan):
-
يُطلب في الحالات غير الواضحة أو المعقدة.
-
يُظهر تفاصيل أكثر من الأشعة العادية، خاصة عند الاشتباه بخراج رئوي أو ورم.
د. اختبار PCR أو اختبار فيروس كورونا:
-
إذا كان هناك اشتباه بعدوى فيروسية مثل COVID-19 أو الإنفلونزا.
هـ. منظار القصبات (Bronchoscopy):
-
يُستخدم في الحالات النادرة أو الشديدة للحصول على عينات مباشرة من داخل الشعب الهوائية.
يعتمد التشخيص على الجمع بين الفحص السريري والصور والتحاليل، مع تكييف الفحوصات حسب حالة المريض وحدّة الأعراض. كل خطوة تساهم في التأكد من سبب المرض ووضع الخطة العلاجية المناسبة.
علاج مرض ذات الرئة
1. المضادات الحيوية (Antibiotics)
-
تُستخدم عندما تكون العدوى ناجمة عن بكتيريا.
-
يُختار نوع المضاد الحيوي حسب:
-
عمر المريض.
-
شدة الأعراض.
-
وجود أمراض مزمنة.
-
نتائج فحص البلغم أو مزرعة الدم.
-
أمثلة شائعة:
-
Azithromycin أو Clarithromycin: في الحالات الخفيفة والمتوسطة.
-
Amoxicillin-clavulanate: خيار جيد في المجتمع.
-
Levofloxacin أو Ceftriaxone: للحالات الشديدة أو عند دخول المستشفى.
-
المدة النموذجية للعلاج: من 5 إلى 10 أيام حسب الاستجابة.
ملاحظة: لا تنفع المضادات الحيوية في علاج العدوى الفيروسية، ويُعد استخدامها العشوائي سببًا في مقاومة البكتيريا للأدوية.
2. مضادات الفيروسات (Antiviral Medications)
-
تُستخدم فقط في حالات العدوى الفيروسية المؤكدة.
-
غالبًا ما يكون العلاج داعمًا، لكن في بعض الفيروسات توجد أدوية محددة.
أمثلة:
-
Oseltamivir (Tamiflu): لفيروس الإنفلونزا، ويُفضل إعطاؤه في أول 48 ساعة من الأعراض.
-
Remdesivir: يُستخدم في حالات COVID-19 الشديدة داخل المستشفيات.
-
لا توجد مضادات فعالة لبعض الفيروسات، ويُترك الجسم ليقاومها مع الراحة والدعم.
3. الراحة وتناول السوائل
-
الراحة التامة ضرورية لمساعدة الجسم على التركيز في محاربة العدوى.
-
السوائل تساعد على:
-
ترقيق البلغم لتسهيل خروجه.
-
منع الجفاف الناتج عن الحمى أو التعرق.
-
-
ينصح بتناول وجبات خفيفة وغنية بالمغذيات لدعم المناعة.
4. خفض الحرارة وتسكين الألم
-
يمكن استخدام:
-
Paracetamol أو Ibuprofen لتقليل الحمى وتسكين ألم الصدر أو الرأس.
-
يجب مراقبة الجرعات وعدم الإفراط.
-
5. العلاج بالأوكسجين (Oxygen Therapy)
-
يُستخدم إذا كانت نسبة الأوكسجين في الدم منخفضة (أقل من 92%).
-
يُعطى الأوكسجين من خلال أنبوب أنفي أو قناع وجه حسب الحاجة.
-
ضروري في الحالات الشديدة أو المصحوبة بضيق تنفس واضح.
6. الدخول إلى المستشفى
-
يوصى به في الحالات التالية:
-
عدم الاستجابة للعلاج المنزلي.
-
أعراض شديدة (ضيق تنفس، زرقة، انخفاض ضغط الدم).
-
كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة (مثل السكري أو القلب أو ضعف المناعة).
-
عند وجود مضاعفات مثل خراج رئوي أو الارتشاح البلوري (تجمع سوائل حول الرئة).
-
7. الرعاية في وحدة العناية المركزة (ICU)
-
تُخصص للمرضى الذين يعانون من:
-
فشل تنفسي حاد.
-
الحاجة للتهوية الميكانيكية.
-
انخفاض ضغط الدم رغم تعويض السوائل.
-
اضطرابات في الوعي.
-
8. العلاج الطبيعي التنفسي (Respiratory Therapy)
-
يُستخدم لتحسين وظيفة الرئة، خاصة في الحالات المزمنة.
-
يشمل:
-
تمارين تنفس عميق.
-
جلسات شفط البلغم.
-
استخدام أجهزة مساعدة على التنفس (مثل جهاز CPAP في بعض الحالات).
-
نصائح عامة أثناء العلاج
-
تجنّب التدخين أو الجلوس بجوار مدخنين.
-
النوم الجيد لتعزيز المناعة.
-
مراقبة الأعراض ومراجعة الطبيب فورًا عند التدهور.
-
إتمام كورس العلاج حتى لو شعرت بالتحسن.
الوقاية من مرض ذات الرئة
1. أخذ لقاح المكورات الرئوية (Pneumococcal Vaccine)
يُعتبر من أهم الوسائل الوقائية، خاصة ضد بكتيريا Streptococcus pneumoniae، وهي من أكثر مسببات ذات الرئة شيوعًا وخطورة.
الأنواع المتوفرة:
-
PCV13 (Prevnar 13):
يُعطى للأطفال بشكل روتيني ضمن جدول التطعيم. -
PPSV23 (Pneumovax 23):
يُعطى للبالغين وكبار السن (65 سنة فما فوق)، أو لمن لديهم أمراض مزمنة مثل:-
أمراض القلب والرئة المزمنة
-
السكري
-
أمراض الكبد أو الكلى
-
ضعف المناعة
-
أهمية اللقاح:
-
يقلل خطر الإصابة بذات الرئة الشديدة.
-
يحد من المضاعفات مثل تجرثم الدم أو التهاب السحايا.
2. لقاح الإنفلونزا السنوي (Influenza Vaccine)
-
الإنفلونزا من الأسباب الشائعة لذات الرئة الفيروسية، ويمكن أن تمهّد الطريق للعدوى البكتيرية الثانوية.
-
يُوصى به سنويًا لكل الأشخاص فوق عمر 6 أشهر، خاصة:
-
كبار السن
-
الحوامل
-
العاملين في القطاع الصحي
-
مرضى الأمراض المزمنة
-
3. غسل اليدين بانتظام (Hand Hygiene)
-
من أهم وسائل منع انتقال العدوى.
-
يجب غسل اليدين بالماء والصابون:
-
قبل تناول الطعام
-
بعد السعال أو العطس
-
بعد لمس الأسطح في الأماكن العامة
-
-
يمكن استخدام معقم اليدين المحتوي على كحول (بنسبة 60% فأكثر) عند عدم توفر الماء والصابون.
4. تجنّب التدخين (No Smoking)
-
التدخين يُضعف الشعيرات الدقيقة في الرئتين (التي تطرد الجراثيم)، مما يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي.
-
يزيد من شدة ذات الرئة إذا حدثت، ويبطئ الشفاء.
5. تعزيز جهاز المناعة (Boosting Immunity)
الحفاظ على مناعة قوية يقلل من فرص الإصابة أو يخفف من شدة المرض.
وسائل تقوية المناعة تشمل:
-
تغذية صحية غنية بالخضروات والفواكه والبروتين.
-
ممارسة الرياضة بانتظام.
-
نوم كافٍ وجودة نوم عالية (7–8 ساعات يوميًا).
-
تقليل التوتر والضغط النفسي.
-
شرب كميات كافية من الماء يوميًا.
-
تجنب الإفراط في تناول المضادات الحيوية بدون وصفة طبية.
6. تجنّب العدوى قدر الإمكان
-
تجنب الاقتراب من الأشخاص المصابين بالسعال أو نزلات البرد.
-
ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة، خاصة في مواسم انتشار الفيروسات.
-
التهوية الجيدة للأماكن المغلقة.
7. التحكم في الأمراض المزمنة
-
الأمراض مثل السكري، الربو، وأمراض القلب تُضعف مناعة الجسم.
-
السيطرة عليها بالأدوية والمتابعة الطبية المنتظمة يساعد في تقليل خطر الإصابة بذات الرئة.
الوقاية من ذات الرئة تعتمد على مجموعة من العوامل المتكاملة: التطعيم، النظافة، نمط الحياة، والتوقف عن العادات الضارة. هذه الإجراءات لا تحمي فقط من الإصابة، بل أيضًا من المضاعفات الخطيرة التي قد تنتج عن المرض.
ذات الرئة مرض قد يكون بسيطًا لكنه قد يتحول إلى حالة خطيرة، خاصة عند الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. لذلك، فإن الكشف المبكر والعلاج السريع والوقاية هي مفاتيح التعامل الفعّال مع هذا المرض.

